يعاني لبنان من مشكلات كثيرة وطائلة، ولعل من يتابع الشأن في الأخبار المتداولة عنها أو حتَّى من حديث المشاهير ورجال المجتمع اللبناني، لوجد هذا ذا أثر واضح في حديثهم. من ضمن هذه المشكلات نجد أنَّ اليد العاملة في لبنان وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والتي ترتبط بها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية من المصانع إلى الورش، ومن المتاجر إلى المنازل تعاني مشكلة واضحة داخل مجتمعهم.

يشكّل كل من العمال اللبنانيين والأجانب ركيزة أساسية لدوران عجلة الإنتاج، لكن هذه الفئة تعيش واقعًا معقدًا، حيث تصطدم القوانين التي تَعِد بالحماية بمجموعة من التحديات على الأرض أبرزها ضعف الرقابة، غياب العقوبات الرادعة، وانتشار العمالة غير المنظمة. ف في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتتالية، يتجلى ملف العمالة كقضية داخل أقطار هذا البلد، والتي تتطلب معالجة شاملة تقوم على التوازن بين حماية حقوق العامل اللبناني وضمان معاملة لائقة للعمالة الأجنبية.
جذور الأزمة تمتد من قبل 2021
الأزمة المرتبطة بالعمالة، وخاصة العمالة المنزلية المهاجرة، لم تبدأ مع الانهيار الاقتصادي بعد 2019 أو القرارات الحكومية عام 2021، بل جذورها تعود إلى عقود طويلة من السياسات غير المنظمة واعتماد لبنان على نظام الكفالة. هذا النظام وضع العامل أو العاملة تحت سيطرة شبه مطلقة لصاحب العمل، من حيث حرية التنقل، الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، وحتى القدرة على فسخ العقد. منذ بداية الألفية، ومع تزايد أعداد العاملات المهاجرات اللواتي قدّرت أعدادهن بنحو 250 ألف عاملة، أصبح الخلل أكثر وضوحًا، حيث أُبقيت هذه الفئة خارج إطار قانون العمل اللبناني، ما جعلها عرضة للتمييز، سوء المعاملة، والعنف النفسي والجسدي.
حسب ما وصفته هيئة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام تحت عنوان "أزمات لبنان تفاقم معاناة عاملات المنازل المهاجرات في لبنان" الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان فاقم هذا الخلل. فحتى قبل الانهيار المالي عام 2019، كانت الرواتب زهيدة (بين 150 و400 دولار شهريًا في أحسن الأحوال)، وغالبًا ما كانت تُحجز جوازات السفر، ويُفرض على العاملات قبول ظروف عمل قاسية دون إمكانية للمطالبة بحقوقهن. ومع الانهيار المالي، تراجعت القدرة الشرائية للأجور، وأصبح كثير منهن يعملن دون تقاضي مستحقاتهن. تقارير الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني منذ ما قبل 2021 أشارت بوضوح إلى أن استمرار تجاهل ملف الكفالة، وغياب إدماج العاملات المهاجرات في قانون العمل، يشكلان جوهر الأزمة.
هكذا، يظهر أن جذور الأزمة ليست طارئة بل تراكمية، مرتبطة بضعف التشريعات، غياب آليات الرقابة، واعتماد الاقتصاد اللبناني على عمالة أجنبية رخيصة تُعامل غالبًا كـ "سلعة بشرية"، كما عبّرت بعض العاملات. لذلك، فإن أي حلول بعد 2021، أوصت الأمم المتحدة في تقريرها أن لا بد أن تنطلق من معالجة الجذور، عبر إصلاح واقعي لنظام الكفالة وإدماج العمالة المهاجرة ضمن إطار قانوني يحمي حقوقها ويمنع استغلالها.
مشكلة العمالة في لبنان.. تعود إلى ساحة 2025
تشهد قضية العاملة الإثيوبية ميسيريت هايلو، التي رُفعت عام 2025 ضد صاحبة عملها ووكالة التوظيف، تحوّلًا نوعيًا في طريقة مقاربة ملف العاملات المنزليات المهاجرات في لبنان. فبدل أن يُنظر إليها كخلاف عمالي أو نزاع حول الأجور، صارت تُصنَّف كقضية "عبودية معاصرة"، وهو توصيف يضع لبنان أمام امتحان قانوني وأخلاقي حاد. هذه الخطوة تكشف أن الانتهاكات لم تعد مجرد حالات فردية بل منظومة راسخة في صميم نظام الكفالة، ما يعيد النقاش العام حول طبيعة هذا النظام وشرعيته أمام المواثيق الدولية.
في السياق نفسه، عاد المجتمع الحقوقي في لبنان وخارجه هذه الأيام ليلقي الضوء بقوة على هذه القضية، معتبرًا أن استمرار تجاهلها يرسّخ صورة لبنان كبلد يتسامح مع العبودية المقنّعة. المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام باتت تتداول الملف بوصفه اختبارًا لمدى استقلالية القضاء وقدرته على فرض حماية حقيقية للفئات الأضعف. وهكذا، فإن التداول الحالي لا يقتصر على التضامن أو كشف الانتهاكات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى الدفع نحو بناء سابقة قانونية يمكن أن تعيد رسم معالم العلاقة بين العاملات المهاجرات وأصحاب العمل، وتفتح الباب لتفكيك منظومة الكفالة من جذورها.

الإطار القانوني لحماية العمالة في لبنان
صدر قانون العمل اللبناني عام 1946، ويُعد من أقدم القوانين في المنطقة العربية، إذ وضع إطارًا لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وحدد الحقوق الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، الإجازات السنوية، والتأمين الصحي. هذه القوانين صُممت لحماية العمال من الاستغلال وضمان بيئة عمل عادلة.
لكن الفجوة الكبيرة تكمن في ضعف التطبيق العملي. فغياب الرقابة الفعالة على المؤسسات وتردد الدولة في فرض العقوبات جعل القانون في كثير من الحالات حبرًا على ورق. هذا الواقع أدى إلى شعور العمال اللبنانيين بالغبن والحرمان من حماية فعلية، بينما يجد العمال الأجانب أنفسهم أمام تحديات إضافية مرتبطة بنظام الكفالة وأوضاع الإقامة، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
العمالة المحلية بين الحقوق المضمونة والواقع الصعب
رغم أن القانون يمنح العمال اللبنانيين حقوقًا واضحة، فإن التطبيق الفعلي يعكس صورة مختلفة. كثير من أصحاب العمل يفضلون العمالة الأجنبية نظرًا لانخفاض كلفتها واستعدادها للعمل لساعات أطول أو في ظروف قاسية. هذا التوجه يُضعف فرص اللبنانيين ويزيد من شعورهم بعدم التقدير.

تصريحات عدد من العمال تعكس هذه المعضلة. فمريم، العاملة في قطاع المطاعم، تقول إنها كثيرًا ما تُستبعد لصالح عامل أجنبي يتقاضى أجرًا أقل، بينما يؤكد سامي، العامل في ورشة نجارة، أن أصحاب العمل يمنحون العمالة الأجنبية ساعات أطول ومهام أكثر رغم أن القانون يفترض مساواة في المعاملة. هذا الواقع جعل العمال اللبنانيين بين حقوق قانونية نظرية وواقع عملي مجحف.
العمالة الأجنبية بين المرونة والاستغلال
من جهة أخرى، العمال الأجانب أنفسهم ليسوا في وضع مثالي، إذ يواجهون تحديات كبيرة مرتبطة بطول ساعات العمل، ضعف الأجور، ونظام الكفالة الذي يجعلهم مرتبطين بالكامل بصاحب العمل. ماريا، وهي عاملة منزلية، تقول إنها تعمل لساعات أطول من المتفق عليها وتتقاضى أجرًا أقل لكنها مضطرة للقبول خوفًا من فقدان عملها.

أصحاب العمل يرون أن العمالة الأجنبية توفر مرونة أكبر، إذ يقبلون بالوظائف التي يرفضها اللبنانيون مثل أعمال الزراعة، النظافة، أو بعض الوظائف الصناعية. ويعترف بعض أصحاب المؤسسات بأن الظروف الاقتصادية تدفعهم لتوظيف الأجانب لتقليل الكلفة، وهو ما يعكس مزيجًا من الضرورة الاقتصادية والاختلال الاجتماعي في الوقت نفسه.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأجنبية
يرى خبراء الاقتصاد أن العمالة الأجنبية ليست بالضرورة عبئًا على الاقتصاد اللبناني، بل في بعض الأحيان تمثل عنصرًا داعمًا للتنافسية وخفض كلفة الإنتاج. وجودها يساهم في استمرار قطاعات لا يقبل عليها اللبنانيون مثل الزراعة وبعض الأعمال الشاقة، كما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية وجذب العملة الصعبة.
لكن في المقابل، المنافسة بين العمال المحليين والأجانب تخلق حالة من التوتر الاجتماعي وتزيد من الإحباط لدى اللبنانيين. فالتصور بأن "اللبناني لا يعمل" في بعض المهن رسخته الأزمة الاقتصادية، وهو ما أشار إليه وزير العمل الذي شدد على أن توظيف الأجانب برواتب أقل ودون ضمانات اجتماعية مسؤولية يتحملها أصحاب المؤسسات. هذه التناقضات تضع ملف العمالة في قلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي.

نحو حلول شاملة ومتوازنة
أمام هذا الواقع، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخل حكومي وإداري شامل. وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر أكد أن الوزارة تمتلك الأدوات الكافية لمعالجة الملف لكنها تحتاج إلى دعم إداري وتنظيمي أكبر. من بين الإجراءات المطروحة: إقفال المؤسسات المخالفة، منع التوظيف غير الشرعي، وتنظيم العمالة الأجنبية بما يضمن حقوق الطرفين.
النقابات العمالية دعت بدورها إلى وضع خطة طوارئ عاجلة تشمل ضبط العمالة الأجنبية، منع استغلالها من قبل أصحاب العمل، وضمان عدم منافستها للعمالة اللبنانية خارج الإطار القانوني. كما طالبت بترحيل من فقدوا صفة النزوح القانوني، وإلا فإنها ستلجأ إلى تحركات ميدانية لحماية حقوق العمال.
الحلول تتطلب رؤية متوازنة: تعزيز الرقابة الصارمة على المؤسسات، تطبيق القوانين بجدية، تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في رفع الوعي، وأخيرًا تطوير سياسات اقتصادية تستوعب العمالة المحلية وتستفيد من مرونة العمالة الأجنبية دون أن يكون ذلك على حساب العدالة الاجتماعية.
ملف العمالة في لبنان ليس قضية قطاعية بل قضية وطنية تمس الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. فبين نصوص قانونية تعِد بالحماية وواقع عملي يكرس الاستغلال لصالح نظرة أرباب العمل، يقف العمال اللبنانيون والأجانب أمام تحديات مضاعفة.
المعالجة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة، النقابات، وأصحاب العمل لضمان تطبيق القوانين وحماية الحقوق. العدالة في العمل ليست ترفًا، بل شرط أساسي لإنتاجية أعلى، مجتمع أكثر تماسكًا، واقتصاد أكثر استقرارًا وتوازنًا.

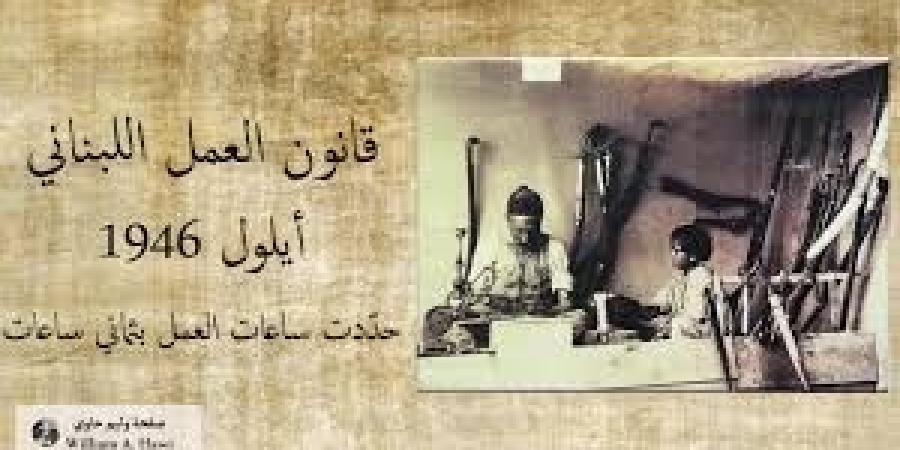
0 تعليق