كتبت بديعة زيدان:
تقدم الروائية العراقية إنعام كجه جي في عملها "صيف سويسري"، الصادر عن منشورات تكوين في الكويت ودار الرافدين في بيروت، رحلة غوص عميقة ومؤلمة في جراحات الذاكرة العراقية المعاصرة.
ولا تفعل كجه جي ذلك عبر سرد تاريخي مباشر، بل عبر تجربة سردية فريدة، بحيث تضع أبطالها، وهم نماذج لأطياف العراق الأيديولوجية المتصارعة، في مختبر نفسي قسري على أرض سويسرية محايدة، لتطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للأوطان المأزومة أن تشفى بعقار طبي؟ وهل يمكن للذاكرة المثقلة بالدم والندوب أن تُغسل في مصحة فاخرة؟
وتدور الحكاية الرئيسة حول دعوة أربعة عراقيين لاجئين في أوروبا للمشاركة في "إجازة صيفية" مدفوعة التكاليف في مدينة بازل السويسرية، هم الذين سرعان ما يكتشفون أنهم ليسوا في رحلة استجمام، بل "فئران تجارب" في دراسة سريّة ترعاها شركات أدوية عملاقة، تهدف لاختبار عقار جديد يُعتقد أنه قادر على علاج "الإدمان الأيديولوجي" والتطرف الفكري.
ويجمع هذا المختبر البشري شخصيات تمثل بتطرفها وجراحها تاريخ العراق الدامي: "حاتم الحاتمي" ضابط الأمن البعثي السابق الملقب بـ"سور الصين"، ويعيش تحت وطأة شعوره بالذنب لمشاركته في حفلة إعدام رفاقه، ويمثل السلطة القمعية التي تعاني من الداخل، و"بشيرة حسون" المناضلة اليسارية التي خرجت من معتقلات النظام بجسد منتهك وروح مثقلة، وتمثل التضحية الثورية التي سُحقت، و"غزوان البابلي" المتدين المنتمي لتيار إسلامي، الذي ذاق مرارة التعذيب في السجون هو الآخر، وفيه ترميز للإيمان الذي تحول إلى أداة صراع، و"دلاله شمعون" الآشورية التي هربت من ماضيها لتتحول إلى "مبشّرة" لـ"شهود يهوه"، باحثة عن خلاص فردي، وترمز للأقليات الباحثة عن هوية في خضم الفوضى.
ويشرف على هذه المجموعة طبيب نفسي شاب من أصل عراقي هو "الدكتور بلاسم"، الذي يحمل هو أيضاً ندوبه الخاصة من وطن لم يعد يعرفه.
وفيما يتعلق بالشخصيات العابرة، تبرز شخصية "سندس"، ابنة "بشيرة"، كرمز للأمل والمستقبل، فهي تُمثل جيلاً وُلد من رحم المأساة لكنه غير ملوث بمراراتها الأيديولوجية، في حين تشكل علاقتها الناشئة بالدكتور بلاسم بصيص النور الوحيد في الرواية، الذي يوحي بإمكانية قيام علاقة صحية بين عراقيين منزوعي الأيديولوجيا.. وهنا يمكن القول إن الشخصيات في "صيف سويسري" ليست مجرد أفراد، بل هي تجسيد حي لتاريخ وصراعات وطن.
وتتشكل ديناميكية الرواية من خلال جلسات "الفضفضة" العلاجية التي يتحول فيها المشاركون إلى رواة لذاكرتهم، حيث تنكأ الجراح، وتُستعاد وقائع الماضي الأليم في مشاهد "فلاش باك" قوية ومؤثرة.
يتخلل السرد أحداث تدور في حاضر"بازل" السويسري، كزيارة معرض لبيكاسو، واكتشاف أن المدينة الهادئة هي مقر "اتحاد المصارف السويسرية" الذي قد يحتفظ بأموال الديكتاتوريين، وأنها كانت مسرحاً لانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول.. هذه الاكتشافات تربط حياد سويسرا المصطنع بتاريخ العالم المعقد، وتكسر عزلة الشخصيات عن ماضيهم الجمعي.
وتحمل الرواية رسائل مركبة وعميقة، وتستخدم رموزاً دالة لتكثيف معانيها، بينها: "الأيديولوجيا كمرض"، وهذه هي الفرضية الأساسية للتجربة السويسرية، وتشكل استعارة مركزية في الرواية، بحيث تطرح إنعام كجه جي سؤالاً جريئاً: هل القومية واليسارية والتدين مجرد عقائد أم هي فيروسات تحتاج إلى "بونبون" (الاسم الذي أطلق على حبات الدواء) للشفاء منها؟
ومن بين ما تناقشه الرواية أيضاً، "سويسرا كرمز"، فمدينة بازل ليست مجرد مكان، بل هي رمز للحياد والنظام والبرود، وهي النقيض المطلق للفوضى والدم والعاطفة التي طبعت تاريخ العراق. لكن هذا الحياد ليس بريئاً تماماً، فهو يخفي خلف واجهاته تاريخاً من التواطؤ المالي والسياسي.
أما "مقهى الوفاق"، المشهد المتخيل في بداية الرواية الذي يجلس فيه حكام العراق التاريخيون، الذين انقلبوا على بعضهم البعض، معاً في مقهى بغدادي فيمثل حلم المصالحة المستحيلة، وتجسيداً سوريالياً لرغبة دفينة في تجاوز الانقسامات التي مزقت البلاد.. "في مقهى بغدادي بلوري البياض.. جلس الملك غازي يلعب الشطرنج مع عبد الكريم قاسم. صدام حسين يشرب الشاي في إستكان نوري السعيد (...) كأن مقهى الوفاق صهريج تنصهر فيه العداوات. يصبح اللامعقول معقولاً".
والسرد في "صيف سويسري" ليس مجرد حكاية، بل عملية علاج نفسي جماعي، فالقارئ، في حالة الدكتور بلاسم، على سبيل المثال، يتحوّل إلى مستمع لشهادات موجعة أصحابها شخصيات تتقاطع مآسيها.
ويمكن التأكيد على أن رواية إنعام كجه جي الأحدث، محاولة أدبية لفهم كيف وصل العراق إلى ما وصل إليه، ليس عبر تحليل سياسي، بل عبر استبطان نفسي لأبنائه الذين كانوا أدوات الصراع وضحاياه في آن واحد.
وتتميز "صيف سويسري" ببناء فني متقن يجعلها عملاً روائياً لافتاً، ففيما يتعلق بالبناء السردي، اعتمدت الروائية على تقنية تعدد الأصوات، حيث تتناوب الفصول على لسان الشخصيات الرئيسة (حاتم، وبشيرة، وبلاسم، وغزوان)، وهذا لم يكن اختياراً عشوائياً، بل ليعكس حقيقة أن تاريخ العراق ليس له راوٍ واحد، بل هو مجموع روايات متصارعة ومتقاطعة، كما أن هذا البناء السردي سمح لكل شخصية بتقديم وجهة نظرها وتبرير ماضيها، ما أضفى على العمل عمقاً وموضوعية.
أما لغة الرواية فهي شعرية، دقيقة، وقادرة على رسم أدق الحالات النفسية، بحيث تمكنت كجه جي من تطويع اللغة لتناسب كل شخصية، فلغة حاتم تحمل بقايا صلابة الخطاب البعثي، ولغة بشيرة تمتزج فيها المرارة بالصلابة، بينما يستخدم غزوان الدعابة كقناع يخفي ألمه.
وشكلت الاستعادات الزمنية (الفلاش باك)، العمود الفقري للرواية، فالحاضر في بازل مجرد إطار هادئ لتفجير براكين الذاكرة، وقد برعت الروائية في توظيف هذه التقنية لربط الحاضر بالماضي، ولإظهار كيف أن الشخصيات، رغم وجودها في سويسرا، لا تزال تعيش حبيسة لحظات مفصلية في تاريخها.
وما يجعل هذه الرواية مميزة أيضاً، قدرتها على تحويل المأساة السياسية الكبرى إلى تجربة إنسانية حميمة وملموسة، فهي رواية حول "أثر" السياسة في أرواح البشر، صيغت بجرأة فنية وفكرية، لتضعنا إنعام كجه جي أمام مرآة الذاكرة العراقية المجروحة، لا لتقدم إجابات سهلة، بل لتجعلنا نتشارك وأبطالها رحلة البحث المؤلم عن معنى ما لما حدث، وعن إمكانية مستحيلة للشفاء، وكأنهم جميعاً يلهثون، كل على طريقته، وراء رغبة حاتم التي عبّر عنها بمقولته الجوهرية: "ذاكرتي تؤلمني وأتمنى قلعها".

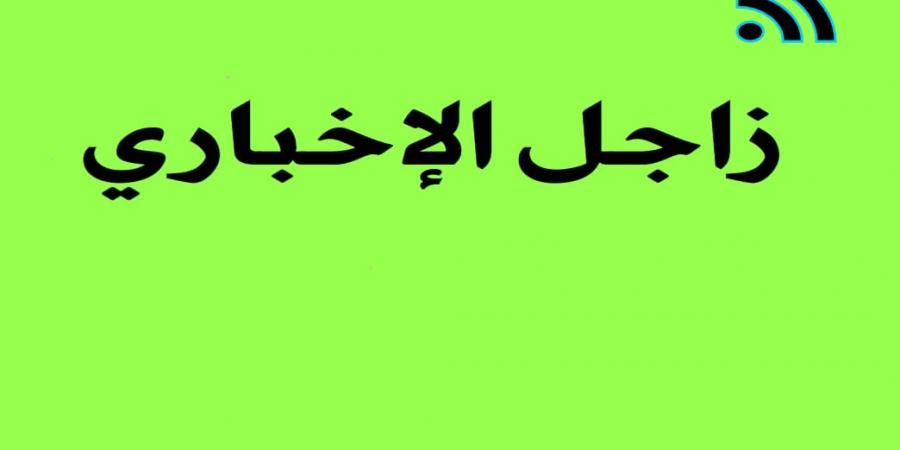
0 تعليق